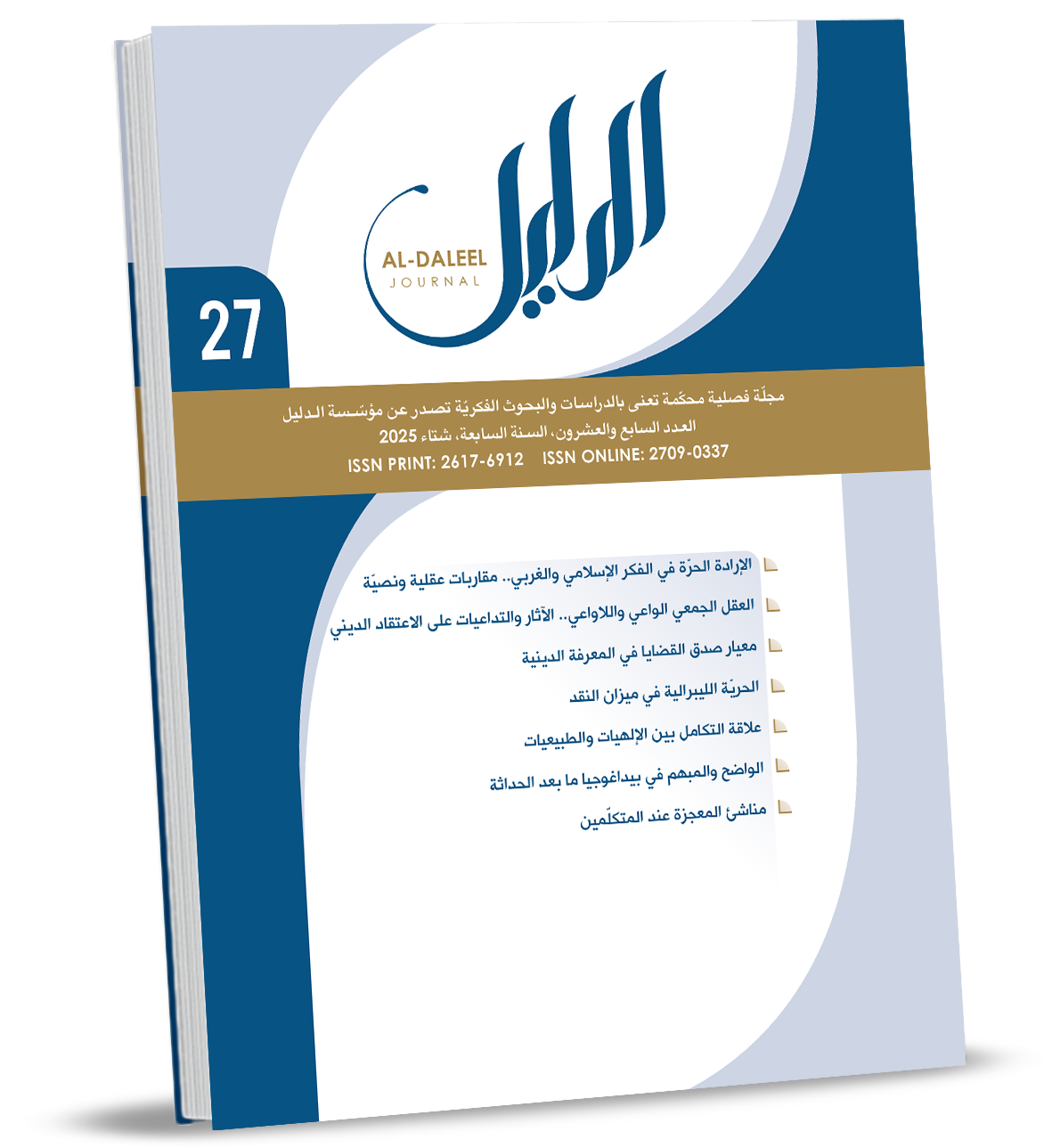دراسة نقدية لنظرية ابن تيمية حول حديث "مدينة العلم"
الأستاذ المشرف: الشيخ الدكتور عبد المجيد زهادت
الطالب: سيد غيور الحسنين
المرحلة: الدكتوراه
خلاصة البحث
مسألة الأعلميّة والمرجعيّة العلميّة للإمام على عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و آله وسلّم من المسائل المطروحة بين المسلمين بشكل خاص. وتوجّه كثير من المحدّثين، والمفسّرين، والمتكلّمين، والفقهاء، وعلماء التاريخ حول هذه المسألة، وبذلوا جهودا كثيرا في إثبات نظرية الأعلميّة والمرجعيّة العلميّة لعلى بن أبى طالب عليه السلام بالآيات والروايات. ومنها حديث "مدينة العلم" الذي صرّح بعض كبار علماء السنّة بحسنه، ومنهم من صحّحه كالطبري، والحاكم، والسيوطي. فدعوى ابن تيمية أنّ حدیث "مدینة العلم" أضعف وأوهى، إفکٌ فضیح. من هذا المنطلق اختار الباحث البحث، وهدفه هو الحصول على معيار صدق الحديث عند ابن تيمية، و نقد آرائه في حديث "مدينة العلم"، والمنهج الذى يعتمد عليه الباحث خلال دراسته هو المنهج الوصفى التحليلى.
يفكّر ابن تيمية أنّ النبي صلى الله عليه وآله و سلّم إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد و لا يجوز أن يكون المبلِّغ عنه واحد، بل يجب أن يكون المبلِّغ عنه أهل التواتر. يرد عليه بأنّ کما لا یضرّ توحّد النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم فی إبلاغه، بعد ثبوت حقّیّته، کذلک لا یضرّ توحّد الإمام فی تبلیغه عن النبی صلى الله عليه و آله و سلّم، بعد ثبوت حقّیّته بالأدلة الکثیرة ومنها حدیث مدینة العلم. إذن نظرية ابن تيمية حول حديث "مدينة العلم" - سنداً و متناً- غير قابل للقبول.
الكلمات المفتاحية
حديث مدينة العلم، ابن تيمية، السند، المتن، النقد.
مقدمة
الحمد لله ربّ العالمين، الصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، و على آله الطيّبين الطّاهرين. أمّا بعد، فإنّ الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عديدة متكاثرة، وشهيرة متواترة. و منها حديث"مدينة العلم" أو حديث "الباب" الذي يدل على أعلميّة علي بن أبي طالب عليه السلام و عصمته.
أجمعت الشيعة على تواتر حديث "مدينة العلم"، وصرّح بعض كبار علماء السنّة بحسنه، ومنهم من صحّحه كمحمد بن جرير الطبري والحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي والسيوطي، وقد أدرج صاحب الغدير قائمة تضم إحدى وعشرين محدثاً من محدثي أهل السنة بين محسّن للحديث ومصحّح له. ولكن ابن تيمية ينكر هذا الحديث من الأصل، و يشكل على متنه بإشكالات واهية و شنيعة، و جميعها قابلة للنقد. من هذا المنطلق اختار الباحث البحث و جعله موضع الدراسة و النقد.
يشتمل هذا البحث على ثلاثة فصول: الأول يحتوى على الكليات، والثاني يتعلق بتبيين سند حديث "مدينة العلم" عند ابن تيمية وإبطال نظريته، والثالث يبحث عن متن الحديث عنده و نقد أفكاره فيه. و في الأخير ذكر النتائج التي توصّل إليها من خلال البحث.
الفصل الأول: الكليات
1- تبيين المسألة
حديث "الباب" أو روايت "مدينة العلم" الذي جعل فيه رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم- نفسه مدينة العلم، و عرّف الإمام على عليه السلام بابها. و ابن تيمية ينكر هذا الحديث سندا و بعد ذلك يشكل على متنه، و جميع الإشكالات قابلة للنقد.
2- السؤال الأصلى و الأسئلة الفرعية
1-2- السؤال الأصلى
ما هو نظرية ابن تيمية حول حديث "مدينة العلم" و ما هو نقدها؟
2-2- الأسئلة الفرعية
1- ما هو إشكال ابن تيمية على سند رواية "مدينة العلم" و ما هو جوابه؟
2- ما هى نظرية ابن تيمية فى متن حديث " الباب" و ما هو نقدها؟
3- سابقة البحث
1-3- تاريخية البحث
حديث "مدينة العلم" من زمن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كان مطروحا بين المسلمين. و ذكره الترمزي و الحاكم في كتبهم الحديثية، و كان موضعا للجدل بين علماء المسلمين. بعض منهم من صحّح هذا الحديث سندا و متنا، و بعض منهم من ضعّفه كابن تيمية. ولكن لم يكتب كتابا مستقلا حول هذا الحديث الأهم إلى زمن متأخر. فكتب السيد مير حامد حسين هندى - من علماء الشيعة- مجلدا كاملا حول هذا الحديث بالتفصيل، و طرحه أحمد المغربى - من علماء السنة- في كتاب مستقل تبيانا لأصحّ سند له.
2-3- المنابع
1-2-3- المنابع المستقيمة
1- کنتوری، میرحامد حسین، خلاصه عبقات الأنوار
2- الشوکانی، محمدعلی، جواب علی معنی حدیث أنا مدینة العلم و علی بابها
3- المغربی، أحمد بن محمد بن الصدیق، فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدینة العلم.
4- صائغ، بدرالدین، أنا مدینة العلم و علی بابها
5- رفيعى، محسن، و شريفى، معصومه، باز خوانى نظريه ابن تيميه درباره حديث باب و نقد آن با تكيه بر منابع اهل سنت، علوم قرآن و حدیث :: سفینه :: پاییز 1391 ، سال 9 - شماره 36 ، از 29 تا 44.
2-2-3- المنابع غير المستقية
1- أمينى، الغدير، ج11، تحت شرح أشعار شمس الدين مالكى.
2- طبسى، محمد محسن، جايگاه روايي ابا صلت هروى از ديدگاه فریقین. ادیان، مذاهب و عرفان :: پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی :: زمستان 1388، شماره 30، از 91 تا 112.
4- أهداف البحث
1- الحصول على معيار صدق الحديث عند ابن تيمية
2- نقد آراء ابن تيمية في حديث "مدينة العلم"
5- منهج البحث
المنهج الذى يعتمد عليه الباحث خلال دراسته هو المنهج الوصفى التحليلى.
6- الجديد في البحث
حتى الآن لم تُكتب مقالة شاملة و لا كتابٌ يستوعب جميع جوانب آراء ابن تيمية حول حديث "مدينة العلم".
7- ثمرة البحث
إذا ثبت سند حديث "مدينة العلم" و متنه بأنه صحيح و قابل للاستدلال فيثبت بذلك المرجعيّة العلميّة لعلى بن أبى طالب عليه السلام، و إحاطته لعلم النبى صلى الله عليه و آله وسلّم، و عصمته. و مع عدم صحّة الحديث لا يثبت به الأمور المذكورة، بل نحتاج في إثباتها إلى حديث آخر.
الفصل الثانى: دراسة سند حديث "مدينة العلم" عند ابن تيمية
1- كلمات حديث "مدينة العلم" فى الكتب الحديثية
ورد حديث "مدينة العلم" أو حديث "الباب" بثلاث عبارات في كتب حديثية:[1]
1- أنا مدينة العلم و علي بابها.[2]
2- أنا مدينة الحكمة و علي بابها.[3]
3- أنا دار الحكمة و علي بابها.[4]
2- تكذيب سند الحديث
قال ابن تيمية: "وأما حَدِيثُ ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ)) فَأَضْعَفُ وَأَوْهَى وَلِهَذَا إنَّمَا يُعَدُّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْمَكْذُوبَاتِ وَإِنْ كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَدْ رَوَاهُ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ." [5]
و يكرّس في مكان آخر بعبارة تالية:
" وَمِمَّا يَرْوُونَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا)) فَأَجَابَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بَلْ مَوْضُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَعَ هَذَا فَهُوَ كَذِبٌ." [6]
النقد
1- ذكر مير حامد حسين هندى 16 طرقا لهذا الحديث و يذكر أنه نُقل عن عشرة أصحاب و هم: الإمام على، والحسن، والحسين عليهم السلام، و ابن عباس، و جابر بن عبد الله الأنصارى، و ابن مسعود، و حذيفة بن يمان، و عبد الله بن عمر، و أنس بن مالك، و عمرو بن العاص.[7] فكيف يكون هذا الحديث موضوعا؟
2- صرّح بعض كبار علماء السنّة بحسنه، ومنهم من صححه كيحيى بن معين، و محمد بن جرير الطبري وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي والسيوطي، و منهم من ذكره مرسلا مسلّما، و منهم من وصف أمير المؤمنين بباب مدينة العلم، و منهم من يصفه في الأشعار بهذه الصفة.[8] مع هذه الأوصاف هل يمكن أن يكون هذا الحديث موضوعا؟ و مع ذلك يقبل ابن تيمية مكانة علماء الحديث المذكور، و يقول عنهم:
"وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ مِنَ الْخِبْرَةِ بِالْأَسَانِيدِ مَا لِأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، كَشُعْبَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَإِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ، وَالْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيَّيْنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَنُقَّادِهِ وَحُكَّامِهِ وَحُفَّاظِهِ الَّذِينَ لَهُمْ خِبْرَةٌ وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِأَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْوَالِ مَنْ نَقَلَ الْعِلْمَ وَالْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (وَتَابِعِيهِمْ) ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ نَقَلَةِ الْعِلْمِ. وَقَدْ صَنَّفُوا الْكُتُبَ الْكَثِيرَةَ فِي مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْآثَارَ، وَأَسْمَاءَهُمْ، وَذَكَرُوا أَخْبَارَهُمْ، وَأَخْبَارَ مَنْ أَخَذُوا عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ مِثْلَ كِتَابِ الْعِلَلِ وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَالْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَأَبِي الْفَتْحِ الْأَزْدِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ." [9]
فلماذا ابن تيمية لم يذكر رواية أحمد بن حنبل و يحيى بن معين[10] وهما صحّحا حديث "مدينة العلم"؟
3- قال جلال الدين السيوطى عن هذا الحديث: قلت: حديث علي أخرجه الترمزى و الحاكم، و حديث ابن عباس أخرجه الحاكم و الطبرانى، و حديث جابر أخرجه الحاكم.... والحاصل أنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن المحتج به، و لا يكون ضعيفا فضلا عن أن يكون موضوعا...[11]
4- ابن حجر يقول عن هذا الحديث: "و هذا الحديث له طرق كثيرة فى مستدرك الحاكم أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغى أن يطلق القول عليه بالوضع."[12]
5- ذكر ابن تيمية أن الترمزى نقل حديث "مدينة العلم" و مع ذلك جعله موضوعا. فهذا دليل على أنّ الترمزى كتب الأحاديث الموضوعة في كتابه، ولكن جميع أهل السنة و ابن تيمية نفسه قائلون بمكانة عالية للترمزى. فدعوى أن حدیث مدینة العلم أضعف وأوهى، ولهذا إنما یعدّ فی الموضوعات، إفک فضیح، لما عرفت سابقاً من صحّة هذا الحدیث واستفاضته وشهرته بل و تواتره، حتى تجلّى ذلک کالشمس المنجلی عنها الغمام على رغم آناف المنکرین الطّغام، فمن العجیب تعامی ابن تیمیّه عن جمیع تلک النصوص والتصریحات من کبار المحقّقین، ومشاهیر نقده الأخبار والحدیث المعتمدین!![13]
الفصل الثالث: دراسة متن حديث "مدينة العلم" عند ابن تيمية
1- تكذيب متن الحديث
قال ابن تيمية: "وَالْكَذِبُ يُعْرَفُ مِنْ نَفْسِ مَتْنِهِ؛ لَا يَحْتَاجُ إلَى النَّظَرِ فِي إسْنَادِهِ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ ((مَدِينَةَ الْعِلْمِ)) لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْمَدِينَةِ إلَّا بَابٌ وَاحِدٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ وَاحِدًا؛ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُبَلِّغُ عَنْهُ أَهْلَ التَّوَاتُرِ الَّذِينَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ لِلْغَائِبِ وَرِوَايَةُ الْوَاحِدِ لَا تُفِيدُ الْعِلْمَ إلَّا مَعَ قَرَائِنَ وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ إمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْتَفِيَةً؛ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَفِيَّةً عَنْ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ الْعِلْمُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ؛ بِخِلَافِ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ: الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ. وَهَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا افْتَرَاهُ زِنْدِيقٌ أَوْ جَاهِلٌ: ظَنَّهُ مَدْحًا؛ وَهُوَ مُطْرِقُ الزَّنَادِقَةِ إلَى الْقَدْحِ فِي عِلْمِ الدِّينِ - إذْ لَمْ يُبَلِّغْهُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ."[14]
النقد
1- کما أنّ نبیّ صلّى الله علیه وآله وسلّم بوحده کاف للإبلاغ عن الله عزّ وجلّ، وأنّه لثبوت حقّیّته غیرمحتاج إلى أن یشارکه فی الإخبار عن الله غیره، کذلک یکفی فی الإبلاغ عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم وجود أمیر المؤمنین علیه السلام، و لا حاجة إلى أن یشارکه أحد فی الإبلاغ کائناً من کان، للقطع بحقّیّه ما یبلّغه عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم. وإنّ حدیث مدینة العلم ـ بالإضافة إلى غیره من الأدلة ـ شاهد صدق على ذلک. ومن هنا جعل أهل العلم والیقین حدیث مدینة العلم من أدلّة عصمة أمیر المؤمنین، وقد وقع التصریح بذلک من نصوص أعاظم المخالفین.
والحاصل: کما لا یضرّ توحّد النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم فی إبلاغه، بعد ثبوت حقّیّته، کذلک لا یضرّ توحّد الإمام فی تبلیغه عن النبی صلى الله عليه و آله و سلّم، بعد ثبوت حقّیّته بالأدلة الکثیرة ومنها حدیث مدینة العلم.[15]
2- وأمّا قول ابن تیمیه: "ولهذا اتفق المسلمون على أنّه لا یجوز أن یکون المبلّغ عنه العلم واحدا، بل یجب أن یکون المبلّغون أهل التواتر، الذین یحصل العلم بخبرهم"[16] فظاهر السقوط جدّاً، لمنافاته لتصریحات أئمة علم أصول الفقه وعلوم الحدیث، کما لا یخفى على المتتبّع لها، فإنّ قاطبة أهل السنّة یوجبون العمل بخبر الواحد، ولم یخالف فی هذا الحکم إلاّ شاذ لا یعبأ به، وإلیک نص عبارة أبی الحسن البزدوی فی هذا المطلب، لیتّضح بطلان دعوى ابن تیمیّه بوجوه عدیدة:
قال البزدوی: "باب خبر الواحد، وهو الفصل الثالث من القسم الأول، وهو کلّ خبر یرویه الواحد أو الإثنان فصاعداً، لا عبرة للعدد فیه، بعد أن یکون دون المشهور والمتواتر، وهذا یوجب العمل ولا یوجب العلم یقیناً عندنا، وقال بعض الناس: لا یوجب العمل، لأنه لا یوجب العلم، ولا عمل إلاّ عن علم. قال الله تعالى: (وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ)[17] وهذا لأنّ صاحب الشرع موصوف بکمال القدرة، فلا ضرورة له فی التجاوز عن دلیل یوجب علم الیقین، بخلاف المعاملات لأنها من ضروراتنا، و کذلک الرأی من ضروراتنا، فاستقام أن یثبت غیر موجب علم الیقین. وقال بعض أهل الحدیث: یوجب علم الیقین، لما ذکرنا أنه أوجب العمل، ولا عمل من غیر علم، وقد ورد الآحاد فی أحکام الآخره مثل: عذاب القبر، و رؤیة الله تعالى بالأبصار، و لا حظّ لذلک إلاّ العلم. قالوا: و هذا العلم یحصل کرامة من الله تعالى، فثبت على الخصوص للبعض دون البعض، کالوطء تعلّق من بعض دون بعض، ودلیلنا فی أنّ خبر الواحد یوجب العمل واضح، من الکتاب والسنة والإجماع والدلیل المعقول........" [18]
ولقد أکثر العلماء من الأدلة المختلفة فی هذه المسألة، وبلغ القول بحجیّة خبر الواحد حدّاً من الخطورة، حتّى ألّف الکثیرون من علماء أهل السنّة فی هذه المسألة مصنّفات مستقلاّت، نصّ على ذلک الحافظ النووی حیث قال: "وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعیّة والحجج العقلیّة، على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرّر العلماء فی کتب الفقه والأصول ذلک بدلائله، وأوضحوه إیضاحا، وصنّف جماعات من أهل الحدیث وغیرهم مصنّفات مستکثرات مستقلات فی خبر الواحد ووجوب العمل به. والله أعلم"[19]
إذن أهل السنة والجماعة يعتمدون على الخبر الواحد كما لاحظت من النصوص الماضية و كلام ابن تيمية يخالفهم.
3- قول ابن تيمية: "خبر الواحد لا یفید العلم الا بقرائن و تلک قد تکون منتفیة أو خفیّة عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة"[20] يرد عليه:
أولا: لکنّ الحق الحقیق بالقبول هو: أنّه لا بدّ للمنصوب من قبل النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم لأجل الإخبار والتبلیغ عنه إلى الأمّة، من حجة ـ من نص أو دلیل ـ تثبت حقیّته، کی تقبل منه الأمّة ما یبلّغه إلیها، ومع وجود النّص أو الدلیل لا حاجة إلى احتفاف خبره بقرینة، حتى یقال بأنها: "قد تکون منتفیة أو خفیة عن أکثر الناس، فلا یحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة"، بل إنّ خبره یکون ـ بسبب النص علیه ـ مفیداً للعلم. وهذا المعنى ثابت فیما نحن فیه، لإفادة حدیث مدینة العلم نصب علی علیه السلام لهذا المنصب، فخبره علیه السلام مفید للعلم والیقین. ومن هنا یظهر أنّ قیاس خبره علیه السلام على خبر غیره من آحاد المخبرین، کقیاس الماء على السّراب، وهو یخالف الحق والصواب.[21]
ثانيا: ثم إنّ التخصیص بالقرآن والسنة لا وجه له، لأنه بناء على ما توهّمه ابن تیمیّة لا یثبت بخبر هذا المخبر علم مطلقاً، سواء کان قرآناً أو سنة متواترة، أو سنة غیر متواترة، فقصر نفی العلم على القرآن والسنّة المتواترة لا وجه له، بل کان مقتضى القاعدة أن یقول: "بالقرآن والسنة غیر المتواترة، بل السنّة المتواترة" کما لا یخفى على البصیر بأسالیب الکلام.[22]
2- نفى عصمة الإمام علي عليه السلام
يقول ابن تيمية: "وَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ الْوَاحِدُ الْمَعْصُومُ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِ. قِيلَ لَهُمْ: فَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِعِصْمَتِهِ أَوَّلًا، وَعِصْمَتُهُ لَا تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ خَبَرِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ عِصْمَتُهُ، فَإِنَّهُ دَوْرٌ، وَلَا تَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنَّهُ لَا إِجْمَاعَ فِيهَا، وَعِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ إِنَّمَا يَكُونُ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً، لِأَنَّ فِيهِمُ الْإِمَامَ الْمَعْصُومَ، فَيَعُودُ الْأَمْرُ إِلَى إِثْبَاتِ عِصْمَتِهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، فَعُلِمَ أَنَّ عِصْمَتَهُ لَوْ كَانَتْ حَقًّا لَا بُدَّ أَنْ تُعْلَمَ بِطَرِيقٍ آخَرَ غَيْرِ خَبَرِهِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَدِينَةِ الْعِلْمِ بَابٌ إِلَّا هُوَ، لَمْ يَثْبُتْ لَا عِصْمَتُهُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا افْتَرَاهُ زِنْدِيقٌ جَاهِلٌ ظَنَّهُ مَدْحًا، وَهُوَ مَطْرَقُ الزَّنَادِقَةِ إِلَى الْقَدْحِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ إِذْ لَمْ يُبَلِّغْهُ إِلَّا وَاحِدٌ."[23]
النقد
1- أمّا قول ابن تيمية: "وإذا قالوا: ذلک الواحد معصوم یحصل العلم بخبره. قیل لهم: فلا بدّ من العلم بعصمته أولا" فالکلام علیه بوجوه:
أولا: کأنّ ابن تیمیّة لا یعلم بأنّ مقتضى مذهب الإمامیة هو القول بعصمة هذا المبلّغ المنصوب للتبلیغ!!
ثانيا: إنّ عصمة هذا المبلّغ الواحد ثابتة من حدیث مدینة العلم، وقد اعترف به بعض المنصفین من أهل السنّة، فیکون حدیث مدینة العلم دالاًّ على مبلّغیة أمیر المؤمنین علیه السلام وعصمته معاً. فبطل قوله: "فلا بدّ من العلم بعصمته أوّلا"
ثالثا: إنّ عصمة أمیر المؤمنین علیه السلام ثابتة من آیات من الکتاب، وأحادیث کثیرة عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم في كتب السنة والشيعة معا.
رابعا: إنّ نصب هذا المبلّغ من قبل النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم هو ـ عند التأمل ـ عین النصب للإمامة والخلافة، فیکون مجرّد النصب دلیل العصمة.
خامسا: لقد دلّت الآیة المبارکة: (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحى)[24] على أن جملة أفعال النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم هی من جانب الله عزّ وجلّ، وعلى هذا یمکن أن یقال بکون الناصب للتبلیغ هو الله عزّ وجلّ نفسه، ولمّا کان هذا النصب عین النصب للإمامة والخلافة عن النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم، وهی لا تثبت إلاّ للمعصوم، فالنصب الإلهی للتبلیغ کاشف عن اتّصاف المنصوب له بالعصمة.
وبما ذکرنا یظهر الجواب عن قوله: "وعصمته لا تثبت بمجرّد خبره، قبل أن یعلم عصمته، فإنّه دور" إذ لا توقُّف لثبوت عصمته على خبره، لکن یمکن إثبات عصمته بخبره أیضاً، لأنّ خبره لیس مجرداً، بل مقرون بالمعجزات الباهرة المتواترة الموجبة للعلم بالعصمة، فلا دور کذلک. [25]
2- وأمّا قول ابن تيمية: "ولا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فیها عند الإمامیة، وإنما یکون الإجماع حجة لأن فیهم الإمام المعصوم، فیعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرّد دعواه" فجوابه:
أولا: أنّه إن أراد نفی الإجماع من أصحاب الضلال فهذا لا یضرّنا أبداً، إذ لا حجّیة لإجماع هؤلاء أصلا، وإن أراد نفی إجماع الإمامیة، فهذا إنکار للبداهة، لأنّ الإمامیة أجمعین قائلون بعصمة هذا الواحد المبلّغ عن الرسول صلّى الله علیه وآله وسلّم.
ثانيا: ثم إنّ المراد من هذا المبلّغ هو أمیر المؤمنین علیه السلام، والنبىّ صلّى الله علیه وآله وسلّم داخل فی الإجماع المتحقّق على عصمته، وعصمة النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم لا یرتاب فیها مؤمن، وإن کان لأهل السنة فیها کلام .
ثالثا: فإنّ الحسنین علیهما السلام داخلان فی المجمعین، وعصمتهما ثابتة بالدلائل القطعیة الأخرى غیر الإجماع.
رابعاً: فی المجمعین سائر أئمة أهل البیت، المعصومون بالأدلة من الکتاب والسنّة. فظهر بطلان دعواه بعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرّد دعواه، وظهر جواز الاستدلال بالإجماع لإثبات عصمة کلّ واحد من الأئمة الأطهار، لأنه لیس من قبیل إثبات عصمة ذاک الإمام بقول نفسه لیلزم الدور، وأمّا عصمة کلّهم، فقد ثبتت بالأدلة القطعیّة الأخرى غیر الإجماع، کما ثبت عصمة کلّ واحد منهم بها. وظهر أیضاً بطلان قوله بعد ذلک: "فعلم أنّ عصمته لو کانت حقّاً، لا بدّ أن تعلم بطریق آخر غیر خبره." لما عرفت من إمکان ثبوت عصمته بخبره، لاقترانه بما یوجب العلم والیقین، فضلا عن ثبوتها بالأدلّة والطرق الأخرى.
وإذ ظهر بطلان کلماته، فقد ظهر بطلان ما قاله کنتیجة لتلک الکلمات، وهو قوله: "فلو لم یکن لمدینة العلم باب إلاّ هو، لم یثبت لا عصمته ولا غیر ذلک من أمور الدّین."
وتحصّل: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام هو الباب لمدینة العلم، وهو المبلّغ الوحید عن النبی الکریم صلّى الله علیه وآله وسلّم، وإذا ثبت ذلک ثبتت عصمته وغیرذلک من أمور الدین.[26]
3- وأمّا ما تفوّه به ابن تیمیّه لشدة عناده وحقده: "فعلم أنّ هذا الحدیث إنما افتراه زندیق جاهل، ظنّه مدحاً وهو یطرق الزنادقة إلى القدح فی دین الإسلام، إذ لم یبلّغه إلاّ واحد." فمن الکفریّات الشنیعة، والله سبحانه وتعالى حسیبه والمنتقم منه یوم القیامة.
لقد علمتَ أنّ حدیث مدینة العلم حدیث رواه أکابر العلماء الثقات عند أهل السنّة، طبقة بعد طبقة، و جیلا بعد جیل، و فیهم من حکم بصحّته، وجعله جماعة من أجلّى فضائل ومناقب النبی والوصی علیهما وآلهما الصلاة والسّلام… وقد وقفت على عبارات هؤلاء الکبار، وإفادات أولئک الأحبار، فیلزم من تقوّل ابن تیمیّه هذا أنّ یکون أولئک الأئمة الکبار والمشایخ العظام: عبد الله بن عثمان القارئ، وسفیان بن سعید الثوری، وعبدالرزاق الصنعانی، ویحیى بن معین، وسوید بن سعید الحدثانی شیخ مسلم، وأحمد بن حنبل، وعباد بن یعقوب الرواجنی شیخ البخاری، وأبو عیسى الترمذی، والحسین بن فهم البغدادی، وأبو بکر البزّار، ومحمد بن جریر الطبری، وأبو بکر الباغندی، وأبو العباس الأصم، وأبو الحسن القنطری، وأبو بکر الجعابی، وأبو القاسم الطبرانی، وأبو بکر القفّال، وأبو الشیخ الأصبهانی، وابن السقاء الواسطی، وأبو اللیث السمرقندی، ومحمد بن المظفر البغدادی، وابن شاهین البغدادی، وأبو الحسن السکری الحربی، وابن بطه العکبری، والحاکم النیسابوری، وابن مردویه الأصبهانی، وأبو نعیم الأصبهانی، وأبو الحسن العطّار، وأبو الحسن الماوردی، وأبو بکر البیهقی، وابن بشران، والخطیب البغدادی، وابن عبد البر، وأبو محمد الغندجانی، وابن المغازلی، وابو المظفر السمعانی، وأبو علی البیهقی، وشیرویه الدیلمی، وعبد الکریم السمعانی، وأخطب خوارزم، وابن عساکر، وأبو الحجاج الأندلسی، ومجد الدین ابن الأثیر، وعز الدین ابن الأثیر،....أن یکون کلّ واحد من هؤلاء زندیقاً جاهلاً!! وإذا کان هؤلاء زنادقة جهالا، فهل تبقى لمذهب أهل السنة من باقیة؟! بل عرفت أنّ هذا الحدیث الشریف قد رواه التابعون العظام، عن صحابة النبی علیه وآله السلام، فاعترفوا به وجعلوه فضیلة لمولانا أمیر المؤمنین، لا سیّما أصحاب الشورى، الذین تلقّوه بالتسلیم، وقد صرّح بثبوته عبد الرحمن ابن عوف منهم تصریحاً تامّاً.
ولقد عرفت سابقا أنّ النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم لم یکتف بمجرّد قوله: "أنا مدینة العلم وعلی بابها"، بل إنّه بذل غایة الاهتمام فی إبلاغ ذلک إلى الأمة، إذ قاله فی یوم الحدیبیّة، مادّاً صوته، وآخذاً بعضد أمیر المؤمنین… إلى غیر ذلک من الأمور الدالّة على اهتمامه بإبلاغ هذا المعنى إلى الأمّة.
وبما ذکرنا یظهر أنّ ما قاله ابن تیمیّه لا یقول به إلاّ "زندیق جاهل، وهو یطرق الزنادقه إلى القدح فی دین الإسلام."[27]
نتيجة البحث
بعد دراسة حديث "مدينة العلم" – سنداً و متناً- وصل الباحث إلى النتائج التالية:
1- منهج ابن تيمية في مقابل الأحاديث في مدح أهل البيت عليهم السلام منهج خاص الذي يشير إلى بغضه و عناده من آل البيت عليهم السلام. فمعيار صدق الحديث عنده غير مشخص.
2- صرّح بعض كبار علماء السنّة بحسنه، ومنهم من صححه كيحيى بن معين، و محمد بن جرير الطبري وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي والسيوطي، و منهم من ذكره مرسلا مسلّما، و منهم من وصف أمير المؤمنين بباب مدينة العلم، و منهم من يصفه في الأشعار بهذه الصفة. فلماذا ابن تيمية لم يذكر روايتهم في كتبه؟
3- کما لا یضرّ توحّد النبی صلّى الله علیه وآله وسلّم فی إبلاغه، بعد ثبوت حقّیّته، کذلک لا یضرّ توحّد الإمام فی تبلیغه عن النبی صلى الله عليه و آله و سلّم، بعد ثبوت حقّیّته بالأدلة الکثیرة ومنها حدیث مدینة العلم.
4- أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام هو الباب لمدینة العلم، وهو المبلّغ الوحید عن النبی الکریم صلّى الله علیه وآله وسلّم، وإذا ثبت ذلک ثبتت عصمته وغیرذلک من أمور الدین.
إذن نظرية ابن تيمية حول حديث "مدينة العلم" غير قابل للقبول.
المصادر و المراجع
1- القرآن الكريم.
2- ابن تيمية، أحمد، تقى الدين، الفتاوى الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1408هـ .ق.
3- ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، أحاديث القصاص، تح: د. محمد بن لطفي الصباغ، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1405هـ - 1985م.
4- ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم و ابنه محمّد، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنوّرة، المملكة العربية السعودية، ط بلا، 1425هـ-2004م.
5- ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تح: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط 1، 1406 هـ - 1986 م.
6- البخاري، علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي ، ط بلا، بلا.
7- الترمزي، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، جامع الترمزى، بيت الأفكار الدولة، أردن، ط بلا، بلا.
8- الحاكم النيسابورى، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط بلا، بلا.
9- رضوانى، على أصغر، سلفى گرى(وهابيت) و پاسخ به شبهات، انتشارات مسجد مقدس جمكران، قم، ط 9، 1393ش.
10- رفيعى، محسن، و شريفى، معصومه، باز خوانى نظريه ابن تيميه درباره حديث باب و نقد آن با تكيه بر منابع اهل سنت، علوم قرآن و حدیث :: سفینه :: پاییز 1391 ، سال 9 - شماره 36 ، از 29 تا 44.
11- السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن، الللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط بلا، بلا.
12- الطبرانى، سليمان بن أحمد، تح: أحمدى عبد المجيد السلخى، ط بلا، بلا.
13- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، لسان الميزان، تخريج: سلمان عبد الفتاح، أبو غدّة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت، ط 1، 1423هـ - 2002م.
14- كنتورى، مير حامد حسين، خلاصه عبقات الأنوار، حديث أنا مدينة العلم، تلخيص: سيد على ميلانى، ترجمه: محمد باقر محبوب القلوب، انتشارات نبأ، تهران، ط 1، 1387ش.
15- المزي، يوسف، جمال الدين أبي الحجاج، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: د. بشّار عوّاد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1413هـ - 1992م.
16- المغربي، أحمد بن محمد بن الصديق، فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي، تح: محمد هادي أميني، إصفهان، مكتبة أمير المؤمنين، ط بلا، بلا.
17- النووي، محيي الدين، يحيى بن شرف، أبو زكريا، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، 1392ش.
[1] - رفيعى، محسن، و شريفى، معصومه، باز خوانى نظريه ابن تيميه درباره حديث باب و نقد آن با تكيه بر منابع اهل سنت، ص33- 35.
[2] - الحاكم النيسابورى، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج3، ص138، حديث4639.
[3] - المغربي، أحمد بن محمد بن الصديق، فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي،ص43.
[4] - الترمزي، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، جامع الترمزى، بيت الأفكار الدولة، أردن، ط بلا، بلا، ص582، ح3723.
[5] - ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، مجموع الفتاوى، ج4، ص410، و راجع: ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ج7، ص515.
[6] - ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، أحاديث القصاص، ص62، و ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، مجموع الفتاوى ، ج18، ص123-124، وص377، ابن تيمية، أحمد، تقى الدين، الفتاوى الكبرى، ج5، ص89.
[7] - انظر: كنتورى، مير حامد حسين، خلاصه عبقات الأنوار، حديث أنا مدينة العلم، ص40.
[8] - راجع: المصدر السابق، ص34- 40.
[9] - ابن تيمية، أحمد، تقى الدين، منهاج السنة، ج7، ص310-311.
[10] - المزي، يوسف، جمال الدين أبي الحجاج، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج18، ص77.
[11] - انظر: السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن، الللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ، ج1، ص334، و راجع: الطبرانى، سليمان بن أحمد، ج11، ص66، باب الظاء، حديث11061.
[12] - السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن، الللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ، ج1، ص334، و العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، لسان الميزان، ج2، ص465، و راجع: رضوانى، على أصغر، سلفى گرى(وهابيت) و پاسخ به شبهات،ص96-97، و الحاكم النيسابورى، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج3، ص138، حديث4639.
[13] -انظر: كنتورى، مير حامد حسين، خلاصه عبقات الأنوار، حديث أنا مدينة العلم، ص693-695.
[14] - ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، مجموع الفتاوى، ج4، ص410، و راجع: ابن تيمية، أحمد، تقي الدين، منهاج السنة النبوية، ج7، ص515-516.
[15] - انظر: كنتورى، مير حامد حسين، خلاصه عبقات الأنوار، حديث أنا مدينة العلم، ص701.
[16] - ابن تيمية، أحمد، تقى الدين، منهاج السنة، ج7، ص515.
[17] - الإسراء، 36.
[18] - البخاري، علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج2، ص370.
[19] - النووي، محيي الدين، يحيى بن شرف، أبو زكريا، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص62.
[20] - ابن تيمية، أحمد، تقى الدين، منهاج السنة، ج7، ص515.
[21] - راجع: كنتورى، مير حامد حسين، خلاصه عبقات الأنوار، حديث أنا مدينة العلم، ص726.
[22] - المصدر السابق، ص726.
[23] - ابن تيمية، أحمد، تقى الدين، منهاج السنة، ج7، ص516.
[24] - النجم، 3-4.
[25] -انظر: كنتورى، مير حامد حسين، خلاصه عبقات الأنوار، حديث أنا مدينة العلم، ص727-728.
[26] - راجع: المصدر السابق، ص728-729.
[27] - راجع: المصدر السابق، ص729-731.