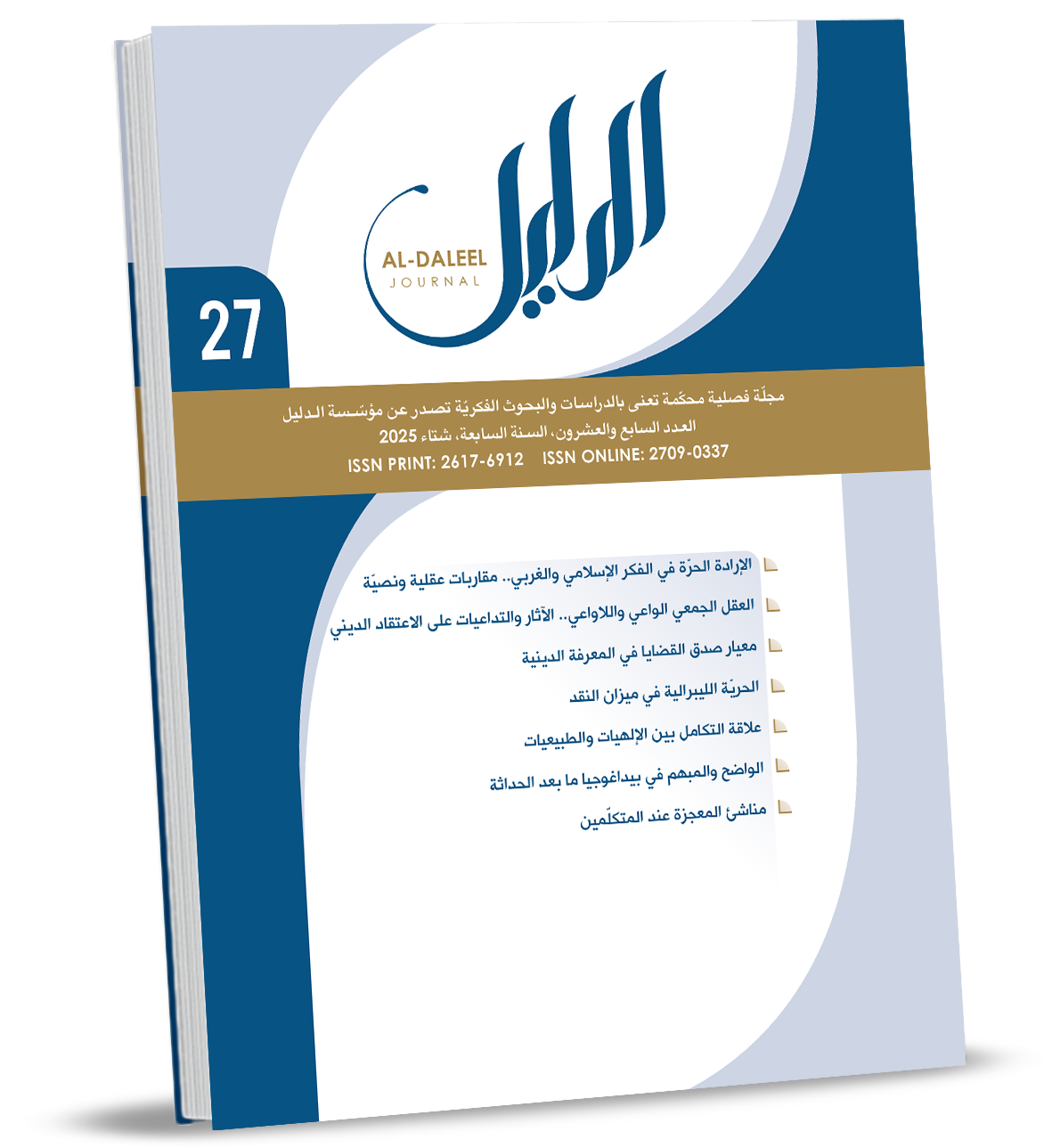دور الحب في نظم الكون
دور الحب في نظم الكون
سيد غيور الحسنين
الحبّ من المفاهيم البدهيّة، وتعجز الكلمات عن وصفها، ولا يمكن إدراك حقيقته إلّا بالمعاناة، وهو شعورٌ لا يتعارض مع القيم الدِّينيّة أو الأحكام الشرعيّة، فالقلوب في النهاية بيد الله وحده. [راجع:الأندلسي، ابن حزم، طوق الحمامة في الأُلفة والألّاف، ص11]
فالحبّ قوّة وجدانيّة خفيّة تسكن أعماق النفوس، تحرّكنا وتوجهّنا، فلا يوجد مخلوق إلّا وتأثّر به بشكل أو بآخر. إنّه طاقة تسري في أرجاء الكون وتتغلّغل في كلّ مكوّناته، لتشمل جميع الكائنات بلا استثناء. يبدأ من الكائنات النباتيّة البسيطة الّتي تنجذب إلى الماء لتروي عطشها، مرورًا بالكائنات الحيوانيّة الّتي يظهر فيها الحبّ بشكلٍّ غريزيٍّ طبيعيٍّ، وصولًا إلى الإنسان، حيث يتجلّى الحبّ في أرقى صوره: الحبّ الإلهي، الّذي يمثّل حالة الاتّحاد الروحي مع الله تعالى.[راجع: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص409-412]
الحبّ والعشق الّذي تحدّث عنه ابن سينا في رسالته:"رسالة في ماهية العشق" هو مزيج متوازن بين المعنى الشائع للحبّ بين الناس والمعنى الروحي العميق الّذي يعبّر عن التوحّد مع الخالق. بين هذين المعنيين، يتجلّى المفهوم الفلسفي للعشق والحُبّ، حيث يرى أنّ كلّ موجود في الكون هو نتيجة شوق دائم نحو الخير الأسمى، وسعيٌ لا ينتهي نحو الكمال المطلق.
الحبّ كطبيعة جوهريّة للموجودات
كلّ الموجودات المدبرة تسعى بفطرتها إلى الكمال الّذي يمثّل خيريّتها، وتنفر من النقص الّذي يمثّل شرِّيتها. العشق والحبّ هو النزوع الطبيعي لكل كائن نحو كماله، وهو سبب وجوده واتّحاده بالكمال. فالموجودات في الكون إمّا فائزة بكمالها وإمّا غارقة في النقص المطلق (المعدومة) وإمّا متردّدة بين الكمال والنقص (في حالة متوسّطة). [راجع: ابن سينا، رسالة في ماهية العشق، ص9-10]
المبدأ الكامل (الإلهي) يفيض الكمال على الموجودات عبر زرع حُبّ كلّي فيها. وهذا الحبّ يضمن انتظام الكائنات وسعيها نحو الاتّحاد بالكمال. فالخير بذاته محبوب، وكلّ نزوع إلى الخير ينبع من الحبّ له. والخير أيضًا عاشق لذاته لأنّه يستحسن ذاته ويسعى للاتّحاد بها. والإله، بوصفه الخير المطلق، هو الغاية في المحبوبيّة والعاشقيّة. ذاته تعبّر عن أكمل حبّ، وهو حبٌّ مطلقٌ وأزليٌّ.
فالحبّ قوة أساسيّة في كلّ الموجودات، سواء كان سبب وجودها أو هو وجودها ذاته، ممّا يبرز مكانته في فهم الطبيعة الكونيّة. ويبيّن ابن سينا أنّ جميع البسائط تمتلك حبًّا غريزيًّا يربطها بالوجود، ويمنعها من الميل إلى العدم المطلق. مثال ذلك أنّ الهيولي الحقيقيّة مادّة خامة غير مكتملة، لا تملك قوامًا ذاتيًّا وتفتقر إلى الصورة لتحقيق وجودها الفعلي. توصف بأنّها "جوهر بالقوّة" لأنّها تحتمل أن تصبح جوهرًا بفعل الصورة. لذا ترتبط بحبٍّ غريزيٍّ للصورة، حيث تسعى دائمًا للاتّحاد بها لتجنّب العدم المطلق. وكذلك الصورة مكوّنٌ جوهريٌّ مقوِّمٌ للجوهر، والّتي توصف بأنّها "جوهر بالفعل" لأنّها تجعل الجوهر موجودًا فعليًّا. لذا تتميّز بحبٍّ غريزيٍّ يظهر في ملازمتها لموضوعها (الهيولي)، وفي سعيها للكمال والعودة إلى مواضعها الطبيعيّة عند الانفصال.
الحب يربط بين الكائنات الحيّة في علاقات متناغمة، سواء في إطار الإنسان أو في الطبيعة. على سبيل المثال، العلاقات التكافليّة بين الكائنات الحيّة كالنحل والزهور تعكس مبدأ الحبّ كطاقة للتعاون والبقاء. يمكن تشبيه الجاذبيّة، الّتي تحافظ على توازن الأجرام السماويّة، بأنّها نوع من "الحبّ الكوني"، حيث تسعى الأجسام للارتباط ببعضها ضمن نظمٍ دقيقٍ.
1- النفوس النباتيّة
يوضّح ابن سينا أنّ النفوس النباتيّة تنقسم إلى ثلاث قوى، ولكلّ قوة منها حُبٌّ خاص بها. مثال ذلك أنّ قوة التغذية تختصّ بالشوق إلى حضور الغذاء عند الحاجة وتحويله إلى طبيعتها. وقوة التنمية الّتي تختصّ بالشوق إلى تحقيق الزيادة الطبيعيّة المناسبة في أبعاد الكائن، وقوة التوليد تختصّ بالشوق إلى تهيئة الكائن لإنتاج مشابه له. ويؤكّد على أنّ هذه القوى الثلاث تحمل في طبيعتها حبًّا غريزيًّا دائمًا. [راجع: ابن سينا، رسالة في ماهية العشق، ص11-13]
2- النفوس الحيوانيّة
كلّ قوة من النفس الحيوانيّة تمتلك حبًّا غريزيًا يوجّهها نحو غايتها. والحُبّ يظهر في الجزء الحسّي الخارجي، كإلف المحسوسات النافعة ونفور الضارة، والجزء الحسّي الباطني، كالميل للتخيّلات المريحة، والجزء الغضبي، كالسعي للانتقام وتجنّب الذل، والجزء الشهواني، أي الشوق للمنفعة الذاتيّة وتحقيق الغايات.
في الطبيعة، يمكن ملاحظة الحبّ في العلاقات بين الكائنات المختلفة. الأمومة، على سبيل المثال، تعكس الحب الفطري بين الأم وصغيرها، وهو ما يضمن استمرار الحياة في الكون. كذلك التوازن البيئي يعكس نوعًا من "الحبّ المتبادل" بين الكائنات الحيّة والأنظمة البيئيّة.
أنواع الحبّ
الحُبّ على أنواعٍ منها: حبٌّ طبيعيٌّ الّذي يتحرّك بطبيعته دون اختيار نحو غايته، مثل القوى النباتيّة والجاذبيّة. وحبٌّ اختياريٌّ الّذي يتحكّم فيه الاختيار، وقد يعرض عن محبوبه عند تخيّل ضرر أكبر. فالقوة الشهوانيّة الحيوانيّة تتوافق مع القوة النباتيّة في الغاية مثل التوليد، لكن الفعل يختلف بين الحبّ الطبيعي (غير اختياري) والحبّ الحيواني (اختياري). فالحُبّ وسيلة لاستبقاء النوع عند الكائنات غير الناطقة، حيث توجّهها نحو غاياتها مثل التوليد، دون إدراك للكلّيات، بخلاف الإنسان. فالحُبّ غريزة عامة، لكنّه يتفاوت بين الكائنات في الوعي والاختيار.
هناك أربع مقدّمات رئيسيّة لبيان العلاقة بين القوى النفسيّة المختلفة في الإنسان وتأثيراتها المتبادلة:
1- تأثير القوّة الأعلى على الأدنى:
عندما تنضمّ قوّة أعلى إلى قوّة أدنى (مثل النطقيّة للحيوانيّة)، تمنحها بهاءً وكمالًا، ممّا يحسن أفعالها ويزيدها دقّةً وحسنًا. مثال ذلك تقوية القوة الشهوانيّة أو الحسّيّة بواسطة القوة النطقيّة لتؤدّي أفعالًا أرقى وأدقّ.
2- تميُّز أفعال الإنسان عن الحيوان:
الإنسان يقوم بأفعال مشابهة للحيوانات كالإحساس والشهوة، لكنّها تتّسم بمزيد من البهاء بسبب وجود النفس النطقيّة. تظهر أفعال مشتركة بين القوى، مثل استخدام الحسّيّة والنطقيّة لاستنباط الكلّيّات، أو تكليف الشهوانيّة لتحقيق غايات تتجاوز اللذّة الذاتيّة.
3- الأولويّة بين الخيرات والمضار:
ليس كل خير يُفضل دائمًا؛ فقد تُترك بعض الخيرات إذا أضرّت بخير أعظم. مثال ذلك شرب الأفيون قد يكون خيرًا لتسكين الألم في حالة المرض، لكنّه مرفوض لإضراره بالصحة العامة.
4- ميل النفوس إلى الحسن والاعتدال:
النفس الحيوانيّة تحبّ الأشياء المتناسبة والجميلة بشكلّ غريزيٍّ. والنفس النطقيّة تحبّ الجمال الأعلى قربًا من المحبوب الأوّل(الله)، وتدرك جمال المعاني والأشياء المنظمّة. [راجع: ابن سينا، رسالة في ماهية العشق، ص15-20]
إذن هناك التفاعل بين القوى النفسيّة، وتحقيق التوازن بين الخيرات، وميل النفس إلى الجمال والتناغم.

الحبّ الإلهي والخير المطلق
كل كائن يحبّ الخير الّذي يفيده في وجوده أو يحقّق له كمالًا، سواء كان ذلك عبر إدراك حسّيّ، عقليّ، أو طبيعيّ. مثال ذلك حُبّ الحيوان للغذاء أو الإنسان للنظام والجمال.
العِلّة الأولى (الله) هي الخير المطلق بذاته، وليست مستفيدةً خيريّتَها من غيرها. والخير المطلق مستوفٍ لكلّ كمالٍ ولا نقصٍ فيه لأنّه يحقّق جميع الخيرات الممكنة. وكونه السبب الأوّل لكل الموجودات يجعله مصدر الخير والكمال لها. لذلك النفوس الإلهيّة (البشريّة أو الملكيّة) تحبّ العِلّة الأولى. وكمال النفوس يتحقّق بمعرفة الخير المطلق والسعي للتشبّه به، سواء عبر الفضائل البشريّة أو تحريك الكون وفقًا لنظامه.
النفوس تتقرّب من العِلّة الأولى عبر أفعالها الكماليّة، وتسعى لتحقيق القربى والفضيلة عبر التشبّه بالخالق. هذه القربى تعزّز حبّ النفوس للخالق باعتباره مصدر كمالها ووجودها. فالعلة الأولى هي الخير المطلق الّذي يحبّه كلّ كائن بطبيعته لأنّه مصدر كماله ووجوده، وتتحقّق محبوبيّته للنفس الإلهيّة من خلال معرفتها به وسعيها للتقرّب منه.
كلّ موجود يحبّ الخير المطلق بطبيعته، لأنّه يمثّل كماله وخيريّته. حتى لو لم تدرك الأشياء هذا الخير بوعي، فإنّ حبّها الغريزي له موجود. والخير المطلق (العِلّة الأولى) متجلٍّ لجميع الموجودات بذاته، ولكن تفاوت الموجودات في قبول هذا التجلّي يعتمد على قصورها أو كمالها. الحجاب عن الخير المطلق سببه النقص أو الضعف في القابل، وليس في المتجلِّي.[راجع: فاطمة الطباطبائي، سخن عشق، ديدگاه امام خمينی و ابن عربی، ص 80]
يصرّح ابن سينا أنّ أوّل قابل لتجلّي الخير المطلق هو العقل الكلّي، ثم النفوس الإلهيّة، ثم القوى الحيوانيّة والنباتيّة والطبيعيّة. كلّ موجود يتشبّه بالخير المطلق بطاقته الخاصة، سواء في حركته، غاياته، أو أفعاله. الجواهر الطبيعيّة والحيويّة تتشبّه بالخير المطلق في غاياتها كالإبقاء، التكاثر، والإظهار. النفوس البشريّة تتشبّه به عبر الأفعال العقليّة والخيريّة، مثل تحقيق العدالة والمعرفة. النفوس الإلهيّة تتحرّك في الكون بهدف استبقاء النظام والنسل، متشبّهة بالخير المطلق في تحقيق الكمال.[راجع: ابن سينا، رسالة في ماهية العشق، ص21-27]
فالخير المطلق (العِلّة الأولى) هو محبوب كلّ الموجودات لكونه مصدر كمالها وتجلّيها. جميع الكائنات تتشبّه به وتسعى نحوه وفقًا لقدرتها، ويُعتبر الحجاب عن الخير المطلق نقصًا في القابل وليس في المتجلِّي.
دور الحبّ في الطب
الحبّ ليس مجرد عاطفة إنسانيّة، بل هو قوة علاجيّة أيضًا يمكن أن تعزّز الصحة العامة وتساهم في تحسين جودة الرعاية الطبّية. إدخال مفهوم الحبّ والرعاية العاطفيّة في الطبّ يسهم في تحقيق تجربة شفاء شاملة تجمع بين الجسد والعقل. مثال ذلك: الحبّ يقلّل من مستويات التوتّر والقلق، ممّا يعزّز وظيفة الجهاز المناعي(Immune system)، حيث ترتبط العلاقات العاطفيّة الصحّيّة بانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض، ويؤدّي إلى إفراز هرمونات مثل الأوكسيتوسين(Oxytocin)، الّتي تخفض ضغط الدم وتحسّن صحة القلب.
النتيجة
الحبّ قوّةٌ محوريّةٌ في الكون تحرّك الكائنات نحو الكمال والخير المطلق، الّذي يتجلّى في الله، ويظهر في الطبيعة كحافز غريزيٍّ للنموّ والبقاء، وفي الإنسان كوسيلة لتحقيق الفضائل والاقتراب من الله. كما يبرز الحبّ كطاقة للتناغم بين الكائنات، ويُعدّ عنصرًا أساسيًّا في فهم الكون وعلاقاته. يربط البحث الحبّ بالجمال والتناغم، مؤكدًّا أهميّته في تعزيز الصحّة العقليّة والجسديّة. في النهاية، الحبّ يُنظر إليه كقوة علاجيّة وروحيّة تحافظ على التوازن الكوني والوجودي.
المصادر
ابن سينا، حسين بن عبد الله، رسالة في ماهية العشق، مؤسسة هنداوي، 2019م.
الأندلسي، علي ابن حزم، طوق الحمامة في الأُلفة والألّاف، مؤسسة هنداوي، 2014م.
طباطبائي، فاطمة، سخن عشق، ترجمه: منوچهر صانعي درّه بيدی، انتشارات حكمت، تهران، 1366 ش، أول.
الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، دار الكتب الإسلامية، ط3، 1396هـ.